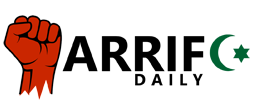هولندا.. بعد المفكر شاشا، أمستردام أكبر مدن هولندا تطلق اسم الشاعر الريفي الراحل أحمد الزياني على قنطرة أخرى في المدينة + ورقة تعريفية

تكريما لروح الراحل الشاعر و الكاتب الريفي/الهولندي “ أحمد الزياني ” ، المجلس الاستشاري لتسمية الأماكن العامة لبلدية أمستردام يقدم على الموافقة الرسمية لتسمية أحد الجسور بأمستردام، وإعطاء الجسر إسم [Zianibrug] ، إعتبارا لمكانته الادبية و الفكرية الانسانية خاصة بهولندا، و نضاله المستميت من أجل حقوق الانسان و المهجرين و حوار الثقافات.
وتأتي هذه المبادرة الرائعة ،-بفضل مجهودات الكاتب الريفي “اسيس اينان” ومساهماته الفنية ونصرته لقضايا الريف العادلة على مستوى هولندا بالخصوص واوروبا على العموم- ؛ اعترافا من الدولة الهولاندية بالمسار الحافل للشاعر والمفكر الريفي “أحمد الزياني”.
ورقة تعريفية بالراحل “ أحمد الزياني ”:
ولد الشاعر الريفي أحمد الزياني سنة 1954 بدار الكبداني/ قبيلة آيث سعيذ بالريف الأوسط، وهو عصامي التكوين إذ كون نفسه بنفسه، وعاش مهاجرا بين الريف والديار الهولندية منذ 1979م، إلى أن توفي يوم الأربعاء 13 يوليوز 2016م بأحد مستشفيات مدينة مليلية الريفية بعد تعرضه لجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة مدة 6 أيام وتمت مواراة جثمانه في مدينة الناظور يوم الخميس 14 يوليوز 2016م.
يعتبر أحمد الزياني أول شاعر ريغي حقق أكبر تراكم شعري أمازيغي مطبوع في شكل دواوين، من خلال إصداره لثلاثة دواوين شعرية:
1/ ديوان ” أذا ريغ گ- زرو/ سأكتب على الحجر” :
يعد الديوان الثاني الذي صدر باللغة الريفية بعد ديوان سلام السمغيني ”ماثوشيذ ءاك رحريق ءينو/هل شعرت بألمي؟” ، وكتب بالحرف الآرامي (العربي)، وقد صدر بهولندا (أتريخت UTRECHT) سنة 1993م، وأعيدت طبعته بالمغرب سنة 1993 م، ويقع في سبع وخمسين صفحة، ويضم (21) قصيدة من الحجم المتوسط، وقد قدم الشاعر ديوانه الجديد بنفسه ليوجهه إلى القراء الأمازيغيين المتعطشين إلى الشعر والتلذذ بالكتابة الإبداعية.
2/ ديوان ” ثريوريوت ي مولاي/ زغرودة للعريس” :
صدر هذا الديوان عن مطبعة أمپريال بالرباط سنة 1998م، ويقع في ست وثلاثين صفحة من الحجم المتوسط، ويضم (18) قصيدة شعرية مكتوبة باللغة العربية، وقد ذيل الديوان بمقطع نقدي للأستاذ فؤاد أزروال على صدر الغلاف الخارجي الخلفي، بينما تولى أحمد عبد الخالقي رسم اللوحة الغلافية الخارجية.
3/ ديوان ”إيغمباب يارزون خ- وودوم نسان ذ گ وودوم ن- وامان/ الوجوه التي تبحث عن نفسها على صفحة الماء” :
صدر هذا الديوان الشعري الريفي عن مطبعة تريفة ببركان سنة 2002م. ويقع في (221) صفحة من الحجم المتوسط، ويضم بين دفتيه ( 50) قصيدة شعرية باللغة اللاتينية: كتابة وترجمة. ويعد أيضا أكبر ديوان شعري أمازيغي في الريف إلى حد الآن. وتكلف بتصميم الديوان وكتابته بالحرف اللاتيني كل من الدكتور حسن بنعقية وأحمد بومالك، بينما تولى أحمد الزياني كتابة استهلال الديوان، في حين اهتم الدكتور بنعقية بتقديم الديوان على ضوء قراءة نقدية شعرية بالفرنسية.
هذا، ويحمل الغلاف الخارجي للديوان صورة لصفحة الماء، بينما الغلاف الخلفي يضم صورة الشاعر مع مقتطف شعري أمازيغي يمثل بؤرة الديوان.
كما كان للشاعر اهتمام بالموسيقى والرواية وأيضا بالمسرح، إذ ألف مسرحية بعنوان: “نونجا” وظف فيها حكاية شعبية تعرف ب”نونجا”، واعتمد فيها المقاربة الكلاسيكية من خلال التركيز على الصراع بين الخير والشر.
وقد استطاع الشاعر أحمد الزياني -خصوصا- من خلال دواوينه الثلاثة تحقيق تراكم نوعي في مجال الإبداع الشعري بالريف، إذ مثل تيار التجديد والتحديث في هذا الشعر، خاصة في ديوانه الثالث الذي عبره فتح طريقا جديدا في الشعر الأمازيغي الريفي، وأحدث قطيعة مع التراث على مستوى الإيقاع والوزن، مقارنة مع باقي الشعراء الريفيين.
وبكل حيوية، شارك الفقيد في عدة مهرجانات شعرية وأمسيات ثقافية وفنية، محليا ووطنيا ودوليا، فحصل على عدة شواهد تقديرية من جمعيات ومؤسسات ثقافية مختلفة تنويها بما كتبه من نصوص شعرية متميزة ومفعمة بالشاعرية والإبداع.
كتب ذ. عبد السلام الخلفي في رثائه مقالا مهما، يقرب الجميع من شخصية هذا الشاعر الريفي الفذ، ننقل منه ما يلي:
□ الهجرة والجمرات الثلاث
لمّا هاجر من قبيلته آيث سعيذ إلى أوروبا في مغامرة كادت أن تودي بحياته – وتلك قصة أخرى- لم يكن يحملُ من زاد العلم إلا ما تعلّمهُ في المسجد ومن مدرسة الحياة القاسية التي ذاق شظفها… لكن بمثابرته وجديته وقدرته على التّحدي تمكّن من أن يُراكم معرفة عميقة نادراً ما تجتمع في شخصٍ عاش الظروف الصعبة التي عاشها.. ففي فترة وجيزة تمكن هذا المهاجر الريفي المعتز بانتمائه من أن يتعلّم اللغة النيرلاندية، ويقرأ بها، بل ويطّلعَ من خلالها على مصادر الثقافة الأدبية للشعب الهولاندي، ويعقد علاقات فكرية مع جامعيين ومثقفين ومهتمين هولانديين أمثال رول أوطن الذي ترجم ديوانه الأول وديوانه الثاني وأمثال كل من أوسمان وأ. سبايتي وميلوف إيجبن… تمكّن أيضاً – وهذه مفارقة كبرى- من أن يُعمق، بأرض العجم، معرفتهُ باللغة العربية الفصيحة ويقرأ بها أمّهات الكتب التي كانت تصدر في المغرب أو تصدر من مصر ولبنان إلخ.
لقد كان في إمكانه أن يفعل كما فعل الكثير من أبناء جيله… أي أن يستكينَ إلى عمل يومي وإلى راتب شهري مريح يقتاتُ به، ويرجع إلى المغرب آخر كلّ سنة يقود سيارة فخمة… لكنه رفضَ هذا الوضع… رفضَ أن ينضاف رقماً آخر إلى آلاف العمّال الذين يعج بهم بلدٌ مثل هولاندا… رفض إلا أن يكون لسان شعب مهاجر مقهور ثقافياً ويعيشُ تمزقاً هوياتياً بينَ البلد الأصل الذي يريد تعريبه وبلد المهجر الذي يريد تغريبه؛ لقد كان يحملُ في قلبه، على الأقل، ثلاث جمرات قاتلة:
جمرة الشعب الذي تشتت في الآفاق وامتهنتْه الأيام ولم يعد عارفاً الطريق إلى أرضه / هويته / ثقافته:
Ini ayi ad ac inigh,
Ad nrmd ad nssn.
Cpar gha nkk nttndrya,
Di tmurt irumyn.
Mrmi gha nkks,
Tbanta a icwwarn?
Ad nddar di tmurt nngh,
Ussan d isbpann.
جمرة اللغة التي أُرِيدَ لها أن تُمحى ببقائها خارج “المكتوب”، وخارج ثقافة المؤسسات؛ فانبرى بحرقة للكتابة بها على الحجر كي لا تنمحي:
Ad arigh, ad arigh, g uZRu, war imppi,
Ad arigh awar g izdjifn ad immysi.
Awar am ughddu di arramt inu ighmi,
ttDgh t zg imma, swigh t d tisessi.
Ad arigh s uZRmaD, ad arigh s ufusi,
mara txsd ra ckk, isi d ari akidi,
Ad nari tarifct, ralla trup ad tghri.
جمرة القيم الثقافية الجماعية التي تركها الأجداد ففرطنا فيها ولم نعد قادرين على مواصلة البناء عليها كما فعلوا هم:
Ini ayi ad ac inigh,
Arr d rbar nnc,
Xzar ghar rbni nni,
Bnan imgharn nnc,
Bnan rbni s tidt,
War ibni ca x rghc,
Imgharn ggin angh,
iyran di gha nptc,
ggin angh axccab,
manis d gha npparwc,
smunn ayraf nsn,
Emmars war iryyc,
Mamc tmsar rxtu,
Wnni nngh inwwc.
إن قلبَ شاعرنا الكبير كان يحملُ في جوفه، إذن، همّ شعب بأكمله… هَمَّ هوية وقيم ثقافية تنكر لها الكُل، وحُملت إليها المعاولُ، من جميع الأصقاع (هنا والهناك)، تريد أن تُهدم ما تبقى منها… إن هذا القلب الذي ناء بهذا الحِمْل الثقيل لم يَعُد قادراً على أن يتحمّلَ أكثر…
□ الانخراط في الحركة الثقافي الأمازيغية هنا وهناك
في هولاندا، ومنذ بداية الثمانينات، انخرطَ الشاعرُ، بحماس كبير، في الحركة الثقافية الأمازيغية؛ انخرط أيضاً في الدينامية الأدبية والفنية والفكرية التي بدأها بالمهجر بعضُ المبدعين والكتاب والباحثين الشباب أمثال المرحوم محمد شاشا ومحمد الأيوبي وعبد الرحمان العيساتي وسعيد السنوسي وغيرهم، فأصدر هناك ديوانه الأول (ad arigh g uZRu) وديوانه الثاني (tilwliwt i mulay)؛ وبالمغرب كان رقماً أساسياً منذ الإرهاصات الأولى لتشكّلِ الموجة الثانية من الحركة الأمازيغية بالناظور (الموجة الأولى تحققت مع جمعية الانطلاقة الثقافية)؛ فلقد كان حضورُه وازناً، ليس فقط بإعادة نشر أعماله الشعرية التي أصدرها في هولاندا أو بطبع إصدارات أخرى جديدة (ighmbab irzzun xf wudm nnsn dg wudm n waman ) أو كذلك بكتابته في فنون المسرح (مسرحية نونجا) وقراره كتابة سيرته الذاتية (في طور الإنجاز كما أخبرني بذلك منذ حوالي سنة على وفاته)، ولكن أيضاً بمشاركاته الفعلية في مختلف الأنشطة الأمازيغية، وكذا بانخراطه ومساعدته على إنجاح المشاريع التي كانت تقوم بها الجمعيات الثقافية المحلية، ثم مواكبته الفعلية لكل المبادرات التي تم إطلاقُها منذ سنة 1990 بتأسيس جمعية إلماس الثقافية، وفي سنة 1993 بتأسيس جمعية ثانوكرا، وبعدها بتوالي تأسيس جمعيات أخرى سواء على الصعيد المحلي أو الوطني. ولا أخفي القول إن أكدت (بحكم المعايشة) أن حضوره الدائم بالمغرب وبهولاندا في نفس الوقت (بسبب تنقله المستمر بينهما) قد شكل بالنسبة للحركة الأمازيغية ذلك الرابط المغذي الذي مكن الفاعلين الأمازيغيين لاحقاً من العمل المشترك ومن تبادل الزيارات سواء على مستوى تنشيط اللقاءات الفكرية والفنية والمسرحية أو على مستوى تعميق أواصر الصداقات الشخصية والتنظيمية بين الأفراد والجمعيات.
ولم يكن شاعرنا منحازاً في كل مشاركاته وإسهاماته إلى أي تيار إلا انحيازه إلى اللغة الأمازيغية وثقافتها، ولذلك فهو لم يدخل أبداً في أية مهاترات سياسية أو إيديولوجية… لقد ظل صديقاً لكل المناضلين الأمازيغيين من جميع التوجهات والتيارات والجهات… فهدفه الأول والأخير كان هو أن يجمع الشتات… شتات الأمازيغ… وأن يعود بهم بالشعر إلى لغة القلب والالتحام… لقد ظل محترَماً من الجميع بل ويحقق إجماعاً حوله يعِزُّ نظيره… وبطبيعة الحال، فإن شعرهُ الذي حقق انتشاراً كبيراً بين الأمازيغ وبين المنظرين والدارسين والطلبة (يُدرَّسُ في عدد كبير من الجامعات المغربية والدولية) قد حقق بدوره نفس الإجماع؛ إنه الشاعر الوحيد الذي تتفاعل مع شعره كل شرائح المجتمع بمختلف حساسياتها السياسية والإيديولوجية وبمختلف مستوياتها التعليمية والثقافية …
□ قارئ نهِمٌ ومنخرطٌ في الدينامية الأدبية والنقاش الفكري
في مقهى النخيل بالناظور توطدت علاقتنا… كُنت ما أزال طالباً بالجامعة… وكان ذلك أواخر الثمانينات عندما التقينا لأول مرة… كنا نجلسُ الساعات الطوال نناقش مختلف القضايا: الأدب الأمازيغي، الحركة الثقافية الأمازيغية، الإسلام والسياسة، الإسلام والأمازيغية، الفلسفة الإسلامية، ملوك الأمازيغ، الثورة الريفية، الدولة الوطنية إلخ. وكنا كلما تعمقنا أكثر في النقاش كلما اكتشفتُ موسوعةً علمية مترامية الأطراف… قارئاً نهماً كان، ومتتبعاً للتوجهات الفكرية والثقافية والسياسية بدقة متناهية… كنتُ أتساءل مع نفسي: كيف أمكن لهذا الشخص الذي لم تسمح له الظروف من أن يستفيد من مدرسة “الاستقلال” وجامعاتها، أن يقرأ كل ذلك الكم الهائل من الكتب في مختلف التخصصات، ويتمثَّلَها ويتخذ موقفاً نقدياً منها… كيف أمكن له أن يبني لنفسه تلك النظرة الثاقبة من الهوية المغربية، ومن الدين، ومن مفهوم الدولة بتلك السلاسة التي كان يُعبّر بها… لقد كان واضحاً في موضوع الثقافة المغربية: علينا أن نعترف بالتعدد كواقعة حضارية وإغناء لحاضرنا ومصيرنا المشترك؛ وكان دقيقاً في علاقة اللغة الأمازيغية بالدين: الإسلام لم يأت لتعريب البشرية ولكن جاء ليهديهم إلى الصراط المستقيم؛ وكان ناقداً للقومية العربية وللإسلام السياسي: لا يمكن أن نُعرّب العالم الإسلامي باسم العروبة ولا باسم الدين، ليس هذا غير ممكن وحسب (أكثر من مليار مسلم لا يتحدثون العربية والعربُ هم أقلية الأقليات) ولكن أيضاً لأن اللغات آية من آيات الله (“ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم”)، ولذلك فإن كل شخص أو نظام سلطوي يريدُ أن يقضي على لغة ما إنما هو إعلان للعنصرية وحرب على الله الذي خلقها وجعل منها آية من آياته.
هكذا كان الشاعر يُدافع عن الأمازيغية في الملتقيات التي كانت تجمعُنا، وهكذا تمكن من أن يخلق لنفسه عالماً فكرياً وفلسفياً منغرساً في لغته وثقافته وانتمائه الهوياتي والديني، ومنفتحاً على الآخر بمختلف تجلياته الحضارية.
واعتباراً لثقافته الأدبية وتضلعه الكبير في اللغة الأمازيغية (كان من أكثرهم إتقانا لها)، بل واعتباراً كذلك لتلك الإحاطة الموسوعية التي كان يتميزُ بها، فإن ذلك انعكس كله على شعره، بشكل يمكن لأي متتبع لأعماله من ملاحظة الانتقالات الكبيرة التي كان يُحدثها من ديوان إلى آخر؛ فقد بدأ ملحمياً يغلبُ عليه الطابع السردي الذي يأخذ بأنفاس المستمع / القارئ في عرضه للتيمات وللأحداث والصور واستكناهه أو استعماله للتراث (الرمزي والحكائي والبلاغي والتاريخي إلخ)، ليصبح أكثر انغراساً في بلاغة الوصف المستلهم لشعرية الصورة المتجذرة في القيم الجمالية للقصيدة الحديثة حيث تتوزعها الاستعارات الموغلة في الرمزية والتجريد، وتحلّيها التشبيهات الأكثر قدرة على التجسيم وعلى التقاط الفكرة أو الشحنة الشعرية المنفلتة والمؤثرة… بل إنه، واعتباراً لانشغاله العميق بإشكاليات المعيرة اللسانية الأمازيغية، كان أول من أصدر ديواناً شعرياً نحى فيه منحى القول الشعري الممعير، وهذا قبل أن يظهر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى الوجود؛ إذ نتيجة لقراءاته المتواترة في علوم اللغة الأمازيغية، واعتباراً أيضاً للنقاشات التي كانت تجري بيني وبينه في الموضوع أصدر سنة 1997 ديوانه الثاني: “تلوليوت ي مولاي” (tilwliwt i mulay)، حاول أن يُقدم فيه لغة شعرية مختلفة تنحو منحى اللغة التي يمكن أن يفهمها القارئ الأمازيغي بغض النظر عن الفرع الذي يتحدث به؛ فكان أول من طبّق القاعدة التي تؤكد أن “كلَّ ما يُيَمْيَمُ في الأمازيغية يُجَمْجَمُ أو يُكَمكَمُ، وأن كلَّ ما يُدْجَمجَمُ يُلَملَمُ تضعيفاً، وأن كلّ ما يُكَمكَمُ يُشَمْشَمُ أو يُيَميَمُ” إلخ. ولذلك جاء ديوانه المشار إليه مختلفاً من حيث استعمالُه، مثلاً، لـ”اللام” بدلاَ من “الراء”: “تلوليوت” بدلاً من “ثروريوث”، و”لالا” بدلا من “رالا”، و”آل” بدلا من “آر”، و”يلِّي- س” بدلاً من “يدجيس” إلخ.).
□ كاتبٌ للأطفال … قادرٌ على أن يُطوّع اللغة لتصبح طفولية
عندما كنا سنة 2006 بصدد إعداد الكتاب المدرسي للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي، كانت تعوزنا، نحن المؤلفين، نصوص شعرية موجّهة للتلاميذ (ـات)؛ واعتباراً للوضع الذي كانت تعيشُه الأمازيغية بحكم توجُّه الشعراء والكتاب إلى الكتابة غالباً للكبار دون الصغار، فقد وجدنا فراغاً كبيراً في إيجاد نصوص بسيطة تجمعُ بين جمالية الأسلوب والمستوى الفكري والنفسي للمتعلمين (ـات) وبين القيم التربوية النبيلة التي يجبُ أن تُبثَّ فيهم؛ اتصلت بصديقي العزيز أطلبُ منه المعونة؛ شرحتُ له المطلوب؛ فلم يمرَّ وقتٌ طويلٌ حتى وجدتُ أمام عينيَّ القصيدة التالية:
Tamurt n tcuni
Tamurt inu,
A tamurt n tmxsa !
Tamurt inu,
A yul g wulawn irsa !
Akal nnm d lpnni; xf arramt inu yugha,
Idurar nnm d tcuni; udm nnsn d azgza,
Sqadan d ighzran; xf ughmbub n RwDa,
Iglmamn n waman; tudrt sigsn tcna.
Tamurt inu,
A tamurt n waman
D idurar n tcuni !
Aqqam ijj n usqsi; ini ayi maymmi ?
lEwin nnm d aghnnij; i fad d tisessi,
Ism nnm d aslham; wi t yisin d aZghali,
Ism nnm d tisddit n taryazt; Xf idmarn immysi,
Ill nnm d mzri; tfukt nnm d agnfi,
A tamurt n tnamit; i yiwd d anami.
هكذا كان شاعرنا الكبير؛ لقد كان مُدركاً للمطلوب بالرغم من كونه لم يشتغل على المواضيع التربوية قبلاً؛ ولكن بإحساسه الأبوي المُرهف، وبانخراطه في الإبداع الأمازيغي بوصفه قضية إبداع وهوية وانتماء إلى أرض، تمكّن من أن ينتج هذا النّصّ الجميل الذي لم ينل فقط قبول فريق التأليف، بل ونال إعجابهم وتنويهم به أيضاً. إنه نصٌّ بقدر ما يبث قيم الانتماء إلى الأرض بسلاسة كبيرة، بقدر ما يقدم الأرض في صورة شعرية جعلت كل المتعلمين (ـات) يتمثلون مغازيها العميقة.
□ محبٌّ للأرض الأمازيغية…ملتزمٌ بالانتماء إليها
لقد كان حبُّه للأرض يتجاوز كل الحدود؛ ولذلك فإننا لا يمكن أن نقرأ له نصّاً دون ما نجد تعريضاً أو إيحاء بتلك الأرض الكريمة المعطاء التي يفيضُ قلبُه فيها غراماً وذوباناً؛ فهو لا يكاد يكتبُ قصيدة حتى تنبعث من ثناياها مشاعر الانتماء الجياشة؛ ولأنه ظل مُلتزماً بالانتماء إليها، فإن هذا الالتزام تجاوز الشعر إلى قرار العودة؛ العودة إلى هذه الأرض التي يريد أن “يلبسها ويغتسل بترابها” كما عبّر عن ذلك في آخر قصيدة له ألقاها بدار الكبداني في غشت 2015، وذلك في إطار اللقاء الرابع لبنات وأبناء آيث سعيذ الذي نظمته “مؤسسة آيث سعيذ”؛ لقد قال في هذه القصيدة، وكأنه يستشعرُ المآل القريب: مآل أن يلبسَ تراب أرضه ويغتسل به من أدران الهجرة الطويلة التي جعلت أمثال “علال” (قصيدة يبث فيها معاناة المهاجر الريفي إلى أوروبا) يفقدُون بسببها انتماء أبنائهم إليها وإلى اللغة الأم؛ يقول:
Ttacigh arramt inu d taEaryant
S wufugh zzaym.
Tamurt inu,
Mrmi d ayi gha tssirdd
Rwpran s ucar nnm?
qaE rbpur kkigh
zzaysn, war tssird.
ولأن الشاعر هو من يقول الشعر صدقاً، ولأنه ظل لأكثر من ثلاثين سنة يدعو للعودة إلى أرض أرادها أن تكون جنة غنّاء:
tamurt inu xsgh tt,
d tabpirt, nccin days ad nZZu,
tamurt inu,
ncc xsgh tt d tara,
nccin xsegh ad zzays nsu.
فإنه عاد إليها… عاد أولاً ليستثمر فيها ما جمعهُ بديار الغربة بعرق جبينه… وعاد ليشرب من مائها ويغرس بها فسائل المزوغة… عاد ليحوّلها إلى تلك الجنة الموعودة… عاد ليُدفن في ترابها الذي قبّلهُ أكثر من مرّة… عاد ليمزج جسده بأجساد أجداده… أوَ ليس التراب، كما يقول:
d aysum n rjdud,
sesswn tt s idammn.
□ يرفضُ أن تُطمسَ ملامحُ الأرض التي ترابُها لحم أجداده
في آخر حوار لي معه على التلفون قبل حوالي شهرين، عبّر لي الشاعرُ بإحساسه المرهف عن تخوفاته من المسار المتسارع الذي تتخذه الثقافة الأمازيغية بالريف وعن خفوت حبّ الأرض لدى الكثير من النُّخب الريفية؛ قال لي منتقداً بعض المبادرات التي تُطلقها بعض فعاليات المدينة (كان يقصد بها مجموع المبادرات الثقافية والمهرجانات والتكريمات التي كان تقوم بها بعضُ النخب):
“إننا نعيشُ، في المرحلة الأخيرة، بعض محاولات طمْس ملامح الأرض الريفية؛ فهناك من يريدُ أن يجعلَ من أرض الريف مستقراً لثقافات ولغات أجنبية، ويدْفع بالأمازيغية إلى رُكنٍ قصيّ كي تنكمش فيه انتظاراً لموتها القريب… ولكأني بهم يستعرّون منها ويبحثون لهم عن انتماءات أخرى… فمنهم من يرتمي في أحضان الشرق، ومنهم من يرتمي في أحضان الغرب، ومنهم من يرتمي في كليهما… إن بعض النخب الفاعلة هداها الله – يقول شاعرنا- تعتقدُ أن العالمية هي أن تُستدعى شخصيات أجنبية وتُعرضَ أفلامُها أو تُلقى قصائدُها أو تُدرسَ مؤلفاتُها أو تُقدّم رقصاتُها في سهرات غنائية ليلية، ثم ينفرط الجميع مهنئين بعضَهم البعض على “النجاح” الكبير الذي حققوه… في حين أن العالمية هي، أساساً، تجذير لثقافتنا الأصيلة وتطوير لها بعَرضها وحمْلِها لتكون منتجة ومتفاعلة مع محيطها… إنهم لم يفهموا أبداً أن العالمية هي تلك التي تأتي من الأرض… من المحلية؛ … ما معنى أن يحضرَ إلى مدينة الناظور سياسيون وفنانون وممثلون ومخرجون عرب وغربيون وآسيويون يتمُّ الاحتفاء بهم بصرف الملايين من الدراهم ما أحوج الأمازيغية إليها، ثم يذهبون دون أن يتركوا أثراً إيجابياً على ثقافتنا ولغتنا ومثقفينا وفنانينا وشعرائنا المحليين إلخ. لقد كان الأجدى – كما يقع في كل العالم- أن يأتي هؤلاء، لكن بشرط أن نُقدم لهم، أولاً، ما أنجزناه، نحن، بلغتنا وثقافتنا وتاريخنا الجماعي، لا ما أنجزوه هُمْ لصالح ثقافاتهم ولغاتهم وفنونهم وإبداعاتهم السينمائية والشعرية إلخ؛ أنظلُّ هكذا مستهلكين بسلبية؟… ماذا استفادت المدينة من كل الهرج والمرج الذي حصل؟ … ماذا استفاد المشتغلون على ثقافتنا الأمازيغية بالناظور من هذا الحضور إلا كيل الضربات القاتلة وتوجيهها إلى هذه الثقافة وما تحمله من قيم أصيلة؟.. هذه الثقافة التي تجاوزت مفاوز القرون، وتعايشت مع حضارات وأنتجت علماء ومثقفين وأبطالاً كباراً أمثال الشريف أمزيان ومحمد بن عبد الكريم الخطابي؟”.
لقد كان يتحدثُ إليّ بمرارة؛ حتى لكأني أحسست من خلال ذبذبات صوته بالدموع تنساب من عينيه؛ والذي آذاه أكثر هو أن هؤلاء الفاعلين الناظوريين لم يفكروا حتى في استعمال اللغة الأمازيغية- لغتهم، أو استحضار بعض الأجهزة التكنولوجية لتحقيق الترجمة الفورية كما فعلوا مع اللغات الأخرى؛ لقد سادت جميعُ اللغات- قال لي- إلا اللغة الأمازيغية !.
□ شهادة أخيرة لابدّ منها
إلتقيتُه صباح ذلك اليوم بمقهى النخيل حيثُ اعتدنا أن نجلس سوياً نتجاذبُ أطراف الحديث حول الأمازيغية وما يجبُ أن نقوم به من أجلها في زمن كان الجميع يتنكرُ لها؛ كان ذلك في أحد أيام الآحاد، صيف سنة 1990؛ كنتُ آنذاك طالباً، وفي تلك السنة حصلتُ على شهادة الإجازة؛ في ذلك الصّباح كنتُ مشوّش الذهن لا أرسو على فكرة؛ فلاحظ تشتت ذهني وسألني:
ماذا فعلتَ في أمر تسجيلك بجامعة ULB وهجرتك إلى بلجيكا؟
أجبتُه:
لقد عدلتُ عن الهجرة.
نظر إليَّ وعلامات الاستغراب بادية على ملامح وجهه؛ ثم سأل:
ولم؟
لم أُرد أن أخبره عن وضعيتي العائلية الفقيرة، ولا عن الجامعة التي تطلبُ ثمناً للتسجيل عالياً أنا غير قادر على أدائه.
نظر يمنة وشمالاً، ثم قال لي:
هيا نخرج لنتمشَّى قليلاً.
في الطريق قال لي:
لم أُرِد أن أُكلمكَ وسط الأصدقاء، ولذلك فضّلتُ أن أستفرد بك حتى أحدثك.
واصل حديثه:
إنني أعرف حالتكَ المادية، وأعرف حالة العائلة، وبدون مقدمات فأنا مستعدٌّ لأساعدكَ حتى تواصل دراستك.
نظرتُ إليه مستغرباً، وقلتُ له:
لكن هذا يتطلبُ الكثير !
قال:
لا عليك، أنا مستعدٌّ لأتكلّف بالتسجيل وبالطائرة وبإقامتك في بروكسيل خلال الشهر الأول أو الشهرين إلى أن تتدبّرَ أمرك. فما رأيك؟
لم أشعر إلا وأنا أُقبِّله.
قُمتُ بما يلزم للتسجيل والسفر. لكن ظروفاً إدارية حالت دون ذلك. ومع ذلك ظلت تلك الالتفاتة منه منقوشة في ذهني إلى الأبد.
ذلكم هو المرحوم أحمد الزياني، كما اقتبسناه من ذ.الخلفي ومن شهادات غيره… فهو ليس بشاعر فقط … وليس بمناضل فقط … ولكنه قبل ذلك إنسان حساس يفيضُ إنسانية… أو كما كتب ذ. ميمون أمسبريذ عن شخصيته قائلا:
《كان أحمد الزياني قيد حياته إنسانا متأملا، تعلو محياهُ مسحةُ حزن دفين استوطنَه وشِعْرَه ولم يُزايِلْهُما البَتّة. حُزن تراجيدي مصدرُه إحساسٌ عميق بالزمن وبالأشياء، وذاكرةٌ سيرذاتية وتاريخية مثقلة بالصدمات، موشومةٌ بالرُّضوض والانقطاعات، ووعيٌ حاد بالظلم الاجتماعي في شتى تجلياته ورفضٌ للتعايش معه مقترنٌ بإدراكٍ مأساوي بصعوبة زحزحة كابوسه الجاثم على صدر فئات عريضة من مواطنيه حتى كاد يصبح قدرا مقدورا. وقد لَهج شعره بكل ذلك؛ حتى إن كثيرا من قصائده تبدو وكأنها رَجْعُ صدىً لصوت شباب الحراك المواطِن الذي انطلق صادحا بمطلب الكرامة ثلاثةَ أشهر بعد رحيله وفي النفس شيئ من … الوطن》.
مثله مثل رفيق دربه في الشعر والنضال الريفي بالمهجر المفكر محمد شاشا الذي توفي قبله بأقل من شهرين، فجمعهما الموت والدفن بين أحضان الريف كما جمعتهما لسنوات مرارة حياة المنفى. وكأن جثمانيهما اجتمعا ليشهدا بعضا من ثمار تضحياتهما، وهو انطلاق حراك الريف الشعبي مباشرة بعد موتهما ببضعة أشهر، رغم أنهما لطالما تمنيا لو يشهدان بكيانيهما سيرورة حراك نضالي شعبي ريفي يساهمان فيه بكينونتهما على أرض الريف الوطن.