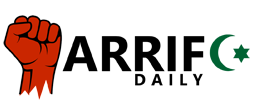“رالّا بويا”… من “أنثى مقدّسة” إلى لازمة تلهم مغنّيات الريف وشعراءه

في ليلةٍ صيفية هادئة، مباشرةً بعد الانتهاء من أشغال الحصاد، تعلو زغاريد، إيذاناً ببدء حفل زفافٍ، في قرى الريف، في أقصى الشمال الغربي لإفريقيا، التي تمتدّ على طول الساحل المتوسطي، والتي يغلب عليها الطابع الجبلي.
تلي هذه الزغاريد مباشرةً، أصواتٌ تصدح بـ”إزرَان ن رالّا بويا”؛ وهي المقاطع الشعرية الشفوية المغنّاة لحظياً، إذ تصطفّ فتيات في مقتبل العمر بشكلٍ متراص، يتقدّمن تارةً، ويتراجعن أخرى، داخل فناء المنزل، وهن يُردّدن: “أ يا رالّا بويا”، كلازمة “مقدّسة” يستحيل من دونها الغزل أو الهجاء، أو غيرها من الأغراض الشعرية الإنسانية.
لازمة رالّا بويا… النداء المُقدّس
يحكي بعضهم، أن رالّا بويا، كانت ملكةً حكمت بلاد الأمازيغ قبل الميلاد، وهي جدّة الملك ماسينيسا الذي حكم بدوره مملكة نوميديا، في القرن الثاني قبل الميلاد.
قد يكون هذا ما يجعل كلمتَي “رَالَّا بُويَا”، لازمةً للشعر الغنائي التقليدي في الريف، حتى أن آخرين رجّحوا أن تكون “رالّا بويا”، “نداءً لأنثى مُقدّسة”.
بهذا، تمكّن أمازيغ الريف، من صناعة “سيرة” لجماعتهم، من خلال شعر “رالّا بويا” الغنائي، إذ تكاد تكون اللازمة مكوّناً جوهرياً لهوية أبناء الريف، وليس مجرّد خاصية ثقافية فحسب، تتردد في كل أغنية تصدح بها مغنّية.
إنها “سرديّة” تناقلها العديد من الباحثين عن الأنثروبولوجي الأمريكي الراحل، دافيد مونتغمري هارت، الذي بحث في الأشكال الثقافية والاجتماعية للمنطقة المذكورة.
يعتقد هارت، أن “أيّ قبيلة لا تُغنّى بها رالّا بُويا، لا تُعدّ ريفيةً حقّاً، وبذلك تكون رالّا بويا أحد معايير الانتماء إلى الريف”.
هذا الرأي الذي يجنح أكثر إلى أسطرة لازمة رالّا بويا، لم يستوعبه بعض الباحثين، في الأشكال والتعابير الثقافية في الريف.
في هذا الشأن، يتساءل الأكاديمي والباحث في أنثروبولوجيا الريف، جمال أبرنوص: “عن أيّ ريفٍ نتحدث هنا تحديدا؟”، مجيباً في الوقت ذاته: “جرت العادة أن نُميّز، في السياقات البحثية، بين أريافٍ متعددة، منها مثلاً الريف التاريخي، والريف الإداري، والريف السوسيو-سياسي، والريف اللساني، وريف الريفيين… إلخ”.
هذه كلّها “أرياف غير ثابتة من زاوية الحدود الترابية، لأنها تتوسع وتتقلص زمنياً ودلالياً، حسب الوقائع التاريخية من جهة، واجتهادات الباحثين من جهةٍ ثانية”، يردف الأكاديمي والباحث في أنثروبولوجيا الريف.
غير أن مقام الشعر، حسب المصدر ذاته، “يفرض أن نتحدث عن ريفٍ خاص؛ هو الريف الثقافي أو الإثنو-ثقافي، إذ يبدو أنه أكثر قدرةً على الإحاطة بأكبر قدرٍ من التعبيرات الإنسانية، فكراً وقولاً ومزاجاً وسلوكاً”.
ويعتقد الأكاديمي والباحث في أنثروبولوجيا الريف، جمال أبرنوص، أن “حصر مؤشرات الانتماء الثقافي إلى الريف، في عنصرٍ ثقافيٍّ واحدٍ ووحيد، مسلك اختزالي إلى أبعد الحدود”، جازماً أن ” وجهة نظر دافيد هارت كانت مدفوعةً بحماسة الباحث الراغب في تأسيس سرديات طريفة ومتطرّفة، يُخلّد بها اسمه في دائرة البحث في هذا المجال”.
تقديس “كولونيالي”؟
دليل أبرنوص على ذلك، أن “المدوّنات الكولونيالية لم تسجّل افتتاح الإيزران الريفية، بلازمة رالّا بويا المعروفة، بل سجّلت لازماتٍ أخرى، أقربها صوتياً إلى اللازمة المذكورة، هي ‘لالّا بوياني'”. ما يدفعنا إلى، “مساءلة مدى معقولية التأويلات المغالية الكثيرة التي حيكت في هذا الصدد، ومن أمثلتها مقترح دافيد هارت، الذي توغّل بحكايته التأصيلية إلى حدود سقوط إمارة النكور، وغيره من الباحثين الذين تحدّثوا عن ملكة تُدعى بويا، لم يُثبت التاريخ وجودها مطلقاً”، في الريف، يضيف أبرنوص.
رالّا بويا… تلبُّس صفة الغنائية. في هذا المجال، يغلب لغوياً رافد أمازيغي يُسمّى “تاريفيت”، إذ إن هناك روافد أخرى للأمازيغية في جنوب البلاد تُسمّى “تشلحيت”، وفي وسطها تدعى “تمازيغت”.
لهذا، يُعدّ رافد “تاريفيت”، اللغة الأمّ بالنسبة إلى أغلب الريفيين الذين يتواصلون بها في حياتهم اليومية، واستطاعوا أن يبدعوا بها شعرهم الذي يتلبّس صفة الغنائية، كما يرى العديد من الباحثين في الأشكال الثقافية في المنطقة.
يحكي بعضهم، أن رالّا بويا كانت ملكةً حكمت بلاد الأمازيغ، وهي جدّة الملك ماسينيسا الذي حكم مملكة نوميديا، في القرن الثاني قبل الميلاد، وأصبحت لازمةً تغنّيها نساء الريف
في كتابهما “ملحمة أدهار أوباران” (دراسة حول قصيدة مجهولة تُخلّد تفَوّق المقاومة على الآلة الحربية الإسبانية في الريف، بين 30 مايو و1 يونيو 1921)، يذهب الباحثان محمد أقضاض، ومحمد الوالي، إلى أن الشاعر الريفي الذي يَنظم مقاطع شعره في أيّ موضوع، “يرتكز على أن التّنغيم الموسيقي هو الذي يعطي لنظمه جماليةً، ويعمّق شاعريته. والغناء هنا، سواء اعتمد الآلة الموسيقية والتّنغيم الشعري، أو ارتكز على هذا التنغيم الإنشادي فحسب، يجعل المتلقّي لا يعبأ كثيراً بصياغة العبارة الشعرية، وتشكّلها المجازي، كما لا يعبأ بالمعاني والدلالات، خاصةً أن التلقّي يقوم على السماع”.
سلطة الإيزري لا تكون ذات فعالية إلاّ في وضعيةٍ تواصلية، ضمن أجواء فرجويّة، إذ إن سؤال التلقّي حاضر بقوّة في هذه الأجواء
ويبدو أن “علاقة الشفوي بالغناء وطيدة، فصَّل فيها الدارسون القول، ذلك أن معظمه منظوم، من حيث بنائه العروضي، على أثر إيقاعات موسيقية مصاحبة”، يقول أبرنوص، في حديثه.
لكن أبرنوص يستطرد قائلاً: “الشعر الريفي الشفوي ليس مغنّىً دائماً، فهنالك أنماط شعرية ريفية غير مغنّاة، كان يتمّ ترديدها في مناسبات خاصّة، من قبيل «ثانظّامت»، الذي كان شائعاً لدى قبائل صنهاجة السراير، إلى حدود العقد الرابع من القرن الماضي، والذي باد بسبب أفول التحالفات (اللفوف)، السوسيو-سياسية التي كانت تخترق الريف، لأن هذه الأخيرة كانت توفّر فضاءاتٍ مناسبةً لترديد قصائده في محافل مخصّصة لتعضيد لحمة الأحلاف بين الأطراف القبلية المختلفة”.
كما أن هناك “نمطاً آخر يُدعى «ثاواريانت»، كان يختصّ به الموسيقيون المحترفون «إيمذيازن»، والذي لم يبقَ منه اليوم غير طيف الذكرى، وبضعة نصوصٍ معدودة”، يردف الباحث في أنثروبولوجيا الريف.
رالّا بويا… ضابط إيقاع الشعر
على مستوى آخر، تتجلى ضرورة ارتباط المقطع الشعري الأمازيغي الريفي، أو ” إزْرَانْ”، بالغناء، حتى يحفظ مكانته بين الأوساط الشعبية التي تناقلته من جيلٍ إلى آخر؛ إذ تتّضح أكثر تجلّيات هذا الارتباط، في ارتكاز المقطع الشعري الأمازيغي في الريف على إيقاع “رالّا بويا”.
يسجّل الباحث في التراث الشعبي والتنمية، عبد الصمد مجوقي، أن “لازمة رالّا بويا، هي الضابط لإيقاع الشعر الأمازيغي الريفي، وقد تكون الضابط الإيقاعي الوحيد، في غياب ضوابط أخرى. لأن إخضاع هذا ‘الإزري’ (المقطع الشعري) للوزن الإسكندري (الاثني عشري)، تعسّف على هذا التراث”.
ثم إنه “داخل الريف نفسها، نجد مناطق أمازيغية، لكنها لا تنطق بالتنويعة الريفية (الصنهاجية مثلاً)، أو تلك التي تعرّبت (قبيلة آيت يطفت)، يقول الباحث في التراث الشعبي والتنمية.
وشدّد المتحدّث نفسه، على أنه “لا يوجد إيقاع غير رالّا بويا، استطاع الباحثون تكريسه لهذا الشعر الأمازيغي الريفي”، معتقداً أن “إخضاعه لأوزان مقترضة من ثقافات أخرى، تعسّف نحن في غنى عنه”.
سياق جماعي
بغض النظر عن سؤال الأصل، لا يستبعد الباحثون في الأدب والشعر الأمازيغيين في الريف، أن يكون الشاعر الريفيّ ينظم مقاطعه الشعرية/ الإيزري، لتكون مسموعةً ضمن سياق التلقّي الغنائي الجماعي والفرجوي.
مجوقي، يؤكد أن “سلطة الإيزري لا تكون ذات فعالية إلاّ في وضعيةٍ تواصلية، ضمن أجواء فرجويّة، إذ إن سؤال التلقّي حاضر بقوّة في هذه الأجواء”.
أنثى مقدّسة للبعض، وحاكمة لمملكة نوميديا للبعض الآخر. أسطورة “رالّا بويا” التي أصبحت لازمةً تُلهم مغنّيات الريف المغربي وشعراءه، وتصنع “هويةً” لموسيقاهم
وتابع صاحب كتاب “المقاومة الريفية من خلال الشعر الأمازيغي الريفي ‘دهار ءوبران’ نموذجاً”، قائلاً إنه “حين يكون هذا النوع الشعري فرديّاً، فسينسلخ من هذه السلطة، ليصير وسيلةً للترويح عن النفس، أو لتزجية الوقت”.
كما أشار الباحث في التراث الشعبي والتنمية، إلى أن “الشاعرة الريفية في الغالب لا تنظم أشعارها خارج سياق وضعيةٍ تواصليةٍ يكون فيه للمتلقّي دور كبير كونه عنصراً أساسياً في الفرجة. بل إن هذه الأشعار تكون وليدة اللحظة، وتفاعلاً مع عناصر التلقّي الأخرى”.
في هذا الإطار، يوضح الباحث أبرنوص، أن “الإيزري، حتى وإن كان فردياً في ظاهره، إلا أنه في حالة توقٍ إلى إيزران أخرى يشكّل معها سلسلةً يشدّ بعضها برقاب بعض، فهو مُصاغ على شاكلة ندٍّ شعريٍّ سابق، كما أنه يترقّب ندّاً لاحقاً ينزع عنه، أو يضيف إليه، سواء على مستوى بنيانه الفني، أو دلالاته، وإيحاءاته، وقصد المتلفِّظ به”.
تحيين وتحوير
هذه الميزة تبيّن أن “إيزري ن رالّا بويا”، لا يرتاح في حال الفردية، بل لا يجد نفسه إلا ملتئماً مع الآخرين. فمن “سمات الشعر المُغنّى، و’إيزران ن رالّا بويا’، نوع منه، قيامه على الطابع الجماعي في الإبداع. فهو ليس تعبيراً فردياً عن تمثّلات ومشاعر فريدة، مثلما قد توحي بذلك الضمائر الخادعة التي يحفل بها، بل تعبير جماعي عن حاجات قوى مختلفة، وترتتبياتها وموازينها”، وفق جمال أبرنوص.
يضيف الباحث في أنثروبولوجيا الريف، هذا الشعر بأنه “شكل تعبيري أصيل، يستجيب لحاجات مختلفة. وهو ملمح ثابت من حيث السمات العامة، من قبيل طابعه الجماعي، وارتباطه بالموسيقى والرقص، ومتغاير يتلوّن بخصوصيات كلّ جماعة على حدة”.
فالشاعر الشعبي الأمازيغي في الريف، كما تذهب إلى ذلك دراسة “ملحمة أدهار أوباران، أنشودة المقاومة الريفية”، مؤكدةً أنه “مهما انطلق شعره شخصياً مرتبطاً بالذات، فشفاهيته تجعل شعره جماعياً، ويؤرخ لتلك السيكولوجية الدينامية، ولهذه القيم والمعايير الجمالية، ليستطيع النص الشعري الشعبي أن يتضمّن آلام وأحزان وأفراح ومسرات وأحلام وهواجس الجماعة التي تنتجه”.
إنه “شعر لا يمكن أن يجسّد رؤيةً واحدةً متناسقةً، تسود في جماعةٍ معيّنة، وينسّقها بوضوح، وعبّر عنها لغوياً وفنياً شاعر مفرد متميز، وإنما هو شعر ينفلت من وحدة الرؤية؛ لأن الرؤية فيه تتراكم وتتجدد، وأحياناً تتغير، باستمرار، خضوعاً لطبيعة التّحيينات التي تفرضها اللحظة، ونتيجة انفلات هذا الشعر من الاسم المبدع الواحد الوحيد. إنه شعر جماعي، في لحظة إنتاجه الأولى، وجماعي في عموديته وأفقيته الإنتاجية المستمرة”، تضيف الدراسة.
وفي استمرارية هذا الشعر الغنائي، تنبثق خاصية التّحيين، ضمن سياقات جديدة ومختلفة باختلاف حامليه ومبدعيه، لأن رحلته في حيّزٍ جغرافي واسع، يتطلب هذا التحيين، أو ذاك التّحوير، حتى تستمرّ سيرة “إزران ن رالّا بويا”، إلى يومنا هذا.
المصدر: رصيف22